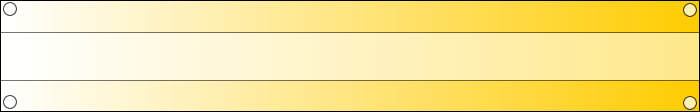DJ-TRAFIK
عضو جديد


 عدد الرسائل : 66 عدد الرسائل : 66
الوظيفة : اختراق المواقع المسيئة للاسلام
دعاء المنتدى : 
جنسيتي : مغربية
مهنتي : 
هوايتي : 
تاريخ التسجيل : 19/08/2008
 |  موضوع: محمود درويش.التجربة الشعرية المغايرة والنقد الغائب موضوع: محمود درويش.التجربة الشعرية المغايرة والنقد الغائب  الثلاثاء أغسطس 19, 2008 9:04 pm الثلاثاء أغسطس 19, 2008 9:04 pm | |
| محمود درويش.التجربة الشعرية المغايرة والنقد الغائب
من "لماذا تركت الحصان وحيداً" إلى "كزهر اللوز أو أبعد"
يذهب النقد الشعري الراهن في غالبيته إلى ثنائية قلّما انحاز عنها ـ المديح الجاهل والهجاء الأعمى ـ محيلاً بذلك الرؤية والرؤيا إلى سياق ثقافي مسيطر في الذهنية العربية القائمة، بنته لغة خطاب إنشائي يبدأ من الآخر وينتهي إليه.
إذ لا تجد الذات حضورها إلا من خلال خارجها، لا من داخلها، متوضعة في شوائب الواقع وحسّيته، لا في مضمره أو تشكّله المتخيل الجديد..
ولذلك تُعيد ما قيل عنه، لا ما يعتمل فيه، فيبقى الكلام في حدود المتصور المنجز، والمنقال، اكثر من الممكن فيه.. ويغدو الناقد وسيطاً بين الشاعر والقارئ، مفسراً النصوص بقوالب جاهزة ومعطاة سلفاً، تصلح لكل النصوص، ولا تصلح لشيء بآن. وتأتي أغلب القراءات النقدية التي تناولت تجربة الشاعر محمود درويش في هذا السياق، لتؤكد دوماً على بلاغة نقدية جاهزة (الانتماء للأرض والإنسان والدفاع عن القضية الوطنية، والغنائية العالية المدهشة والصور الحاذقة، والموسيقا العذبة و.. الخ. أو العكس تماماً كما يسعى البعض إلى مطاردة مواقف الشاعر السياسية والتباساتها، ليسقطها على النصوص مشككاً، ليس في جمالية النصوص الشعرية وحسب، بل وفي وطنيته أيضاً، وفي الحالتين تمارس هذه الكتابة بؤساً نقدياً مطبقاً، يجد مرجعيته في عقل الغائي يتماهى مع تصورات ذاته، ولا يبصرها إلا من خلال ذوبانه في الآخر أو رجمه بكلِّ عداوة ممكنة، ناسياً أو متناسياً مساحة الاتفاق والاختلاف في القراءة، ونسبيتها الموضوعية.
لأن إعادة تشكيل النص نقدياً يستدعي القدرة على التقاط الغث من السمين فيه ـ إن صح القول ـ وإظهار ثقافته، وتبيان مستوياتها، وإدراك بنائيته الجمالية، دونما إدعاء بالقول الفصل إذ غالباً ما نطيع الشعر أكثر مما نستطيعه مادام هو "الكشف عن عالم لا يكف عن الكشف" بتعبير "رينيه شار" نظراً لدينامية لغته, وسعة آفاقها، وتغير تناولاتها بتغير المعطيات حولها، فيقول الشعر تجلياته المتواصلة في صيرورتها الممكنة دون حدود قصوى ونهائية، وبالتالي لا يمكن القطع في الرأي النقدي، ومعياريته.
فلا تأخذنا غواية الامتلاك وتدفعنا إلى "أصول" في المحاكمة النقدية وممارسة استبداد على رؤية ومعالجة النص الجمالية للمعطيات، فأدوات الشاعر، وطريقة تعامله مع الموجودات حوله، ورؤيته "للحفر" في الكلام هي "مربط الفرس" ولها الأولوية في النقد الشعري كما أعتقد. ولا نجد غضاضة في الاعتراف بأن بعض التجارب الشعرية تملي على النقد غوايتها وتدفعها لقراءة مغايرة، بل وتدفعنا بقوة إلى المساءلة من داخلها، وهذا النقد لا يستحضر من الغائب أو المسبق المعلّب ضمن منهج قائم ومطمئن بل تفرضه بصيرة الشعر والناقد معاً، في التناغم والتواتر والاختلاف في داخل فضاء النص الشعري النقدي، فالنقد هنا يتوغل في نسيج البناء ليقول كيفيته كوجود ووجوب، والاختيار النقدي لتجربة دون أخرى لا يعني بالطبع اختصار الحدائق بوردة واحدة مهما حملت من رائحة مشتهاة، إنما هو السعي لوصول مجرى نهر كبير لا التحديق في ضفة من ضفتيه.
خصوصية التجربة الشعرية:
وتكتسب تجربة محمود درويش خصوصيتها على هذا الصعيد، بعيداً عن نجومية الشاعر وسطوته في المشهد الشعري العربي بعامة والفلسطيني منه بخاصة. فقد كثرت الدراسات التي تواكب مسيرته بين توثيق وتصنيف ومتابعة، ويلاحظ في أغلب ما كتب وقيل التركيز على تفسير النصوص وإحالتها إلى مصادرها الثقافية وسياقات مرجعيتها المعرفية، وتوظيفها، وإشكالية الآخر فيها، وتماهيها مع القضية الوطنية و.. الخ.
ولا أظن أن شعرية محمود تتأتى من خلال موضوعاتها على أهميتها، ولا من خلال ترسيم العلاقة مع الآخر، وانعكاساتها في شعره، بل أجد من الأهمية بمكان النظر العميق إلى تطور التجربة من حيث تشكيلها الشعري، وعدم الاكتفاء بالتوصيف والتصنيف للنواظم العامة الخارجية.
بل الدخول في مستويات الكيفية التي يشكل فيها الشاعر قصيدته، وهي التي تحدد خصوصية الشاعر وتميزه ـ إن وجد ـ وهي وظيفة النقد الحقيقي التي لا تضيء التجربة وحسب، بل وتساهم مساهمة كبرى في تطورها ـ إن استطاعت ذلك وهذا ما يفتقده شعر محمود درويش، والشعر العربي عموماً.
فنحن أمام كتابة شعرية لعبت دوراً رئيسياً ومفارقاً في جماليته للسائد في الشعر الفلسطيني، واحتشاده العارم بمفردات الموضوعة، السياسية لا الرؤية السياسية، فالمباشرة و"التعبوية" و"الإعلامية" و"التبشيرية" وهذه بعض سمات ذلك النمط المأسور بتناولاته، والمختزل عالمه ضمن حدود منظور إيديولوجي معطى مسبقاً، يُعيدُ اجترار مقولات البيان السياسي، وفق ثنائية أحياها التكرار (الفلسطيني البطل والفلسطيني الضحية) غافلاً أو متغافلاً عن قارته الداخلية، ومكنوناتها الإنسانية العميقة، قافزاً عن كلّ المتغيرات التي حدثت وطالت أبجديات تحديداته الأولى، ومفردات واقعها... بدءاً من العلاقة مع مفهوم الوطن وليس انتهاءً بالنظر للفلسطيني ككائن بشري غير مجرد، يضعف ويحب ويضجر ويقرف و.. إلخ.
وإذا كانت مثل هذه السمات لها ما يبررها في انطلاقة العمل الفلسطيني المقاوم لإيصال صوت فلسطين إلى العالم، إلا أن استمرارها وإلى وقت غير قصير في المشهد الشعري الفلسطيني قد قلل كثيراً من جمالية هذا الشعر، وأهميته في خارطة الشعر العربي وإضافاته.
الصوت والصمت في شعر محمود درويش
لم تواجه القصيدة العربية الحديثة كما أرى نقداً حقيقياً، ولا تشكّل الندرة من الدراسات الجادة التي كتبت هنا وهناك مرجعية كافية، وافية، لقراءة هذه القصيدة ومحكمتها بشكلٍ موضوعي. إذ اقتصرت تلك التناولات النقدية على تبسيط النصوص، ومطاردة معانيها، ضمن تقسيمات "مدرسية" تقوم على "ثنائيات شعرية"، تحيلنا إلى قراءة بائسة في فهم الشعر ونقده، مبنية على نزوعات شكلانية في النظر إلى الفعالية الشعرية ضمن حدود ملامساتها الخارجية، ووظيفتها الاستعمالية. إذ يستغرقها البيان البلاغي القديم، والقائم على النظر إلى الشعر كوصفٍ في الكلام لا التأسيس فيه، وبالتالي يصبح القول الشعري في تضاعيف هذه النزوعات وقفاً على ثنائية الشكل والمضمون، حيث يعثر الشكل على قيمته من خلال ضبط أوزان الخليل و"تفعيلاته"، وزخرفة اللغة، وجزالة ألفاظها، ومتانة تراكيبها، ورصانة أسلوبها وعاطفة شاعرها، ويتعرف المضمون صورته في تصديه "بانفعالات جياشة وفوارة" للقضايا الشمولية، فيتعكز التشكيل الشعري على تحديداته المسبقة هنا بدلاً من الحالة، وعلى المألوف والمعطى والنمط بدلاً من المبتكر والمدهش والمتفرد، فتغدو اللغة الشعرية بمجرد وسيلة للإفصاح عن مشاغلات الحواس الخارجية، تقول أكثر مما تكشف، وتنظم أكثر مما تعبر، يلوكها غبار العموميات ويستغرقها الركض خلف الإيقاع الخارجي دون أن تتجاوزه، فتهيمن الذاكرة على حاسة التخييل، والفكرة المسبقة على الحالة الشعرية، وتبنى الصور الشعرية بعين العقل، وتخفت الإضاءات الداخلية للغة، ويعلو الصوت الخارجي على صمت الداخل وتأملاته، فلا يذهب النقد إلى جوهر البناء الشعري ونواظمه الجمالية، بل يكتفي بما هو منجز ليتناسب مع حدود معرفته للشعر ونقده.
لذلك حاولنا في دراستنا لشعر محمود درويش عبر نماذج محددة أن نسهم أو نحاول الإسهام في بعث حالة نقدية مغايرة لوصفات المدح والقدح التي نطالعها هذه الأيام.. ففي سياق النظر إلى الفعالية الشعرية كحالة مثلى من حالات القبض على التجربة الشاملة، بما يعنيه ذلك من أسئلة والتباسات عديدة حول طبيعة اللحظة الشعرية، وقدرتها على تمثّل حركة الموجودات حولها دونما اهتزاز في حركة الجدل بين الداخل والخارج في النص الشعري، أو خضوع لهشاشة المعطيات الخارجية، وخدشها الذهني والوصفي لروح الشعر وانبثاقاته الداخلية الحارة.
تأتي تجربة محمود درويش في هذا المنحى محاولة توطيد نسقها الشعري الطامح في الانفلات من ربقة التصورات المنجزة للغة الشعرية، وبيانها البلاغي القديم القائم على وصفية الكلام لا التأسيس فيه.
فإن كان علو الصوت الخارجي يقود إلى مشاغلات الحواس، وانكشافها الأولي خارج الدفقة الشعرية بما يعنيه ذلك من تصاعد وتيرة التمثل الوصفي للغة، والدخول في مطبات الاحتشاد، والسرد، وكثرة الشروحات في القول الشعري، فإن الصمت في سيلانه يصبو إلى المستتر والكياني، ليقول أسئلته الجمالية الأخرى في بحثٍ لا متناه عن مشغولات الداخل، عن المكتوم من دلالته لا المكشوف منها، وعن المميز والمتفرد لا المتشابه والمألوف.
في الصوت يتنافى النص الشعري عمودياً باتجاه تحديدات الكلام المسبقة، وفي الصمت تندفع الانبثاقات التأملية نحو السحري واندفاعاته، فالصوت ينقل وينظم ويقول، والصمت يُؤسس ويشكّل ويكشف.
محولاً الشعرية إلى إبصار للذات وانكشاف وعيها في مرآة العالم.. وكي لا نغوص ونكرر في التحديدات النظرية أكثر، سنتناول في دراستنا هذه إصدارات الشاعر من عام 1990 ـ حتى العام 2005م وهي حسب ترتيب صدورها، باستثناء العملين ما قبل الأخير، وهما: حالة حصار ولا تعتذر عما فعلت" "لماذا تركت الحصان وحيداً" 1995، و"سرير الغريبة" 1998، و"جدارية العام 2000م، و"كزهر اللوز أو أبعد" 2005.
ففي "لماذا تركت الحصان وحيداً" يتابع محمود درويش سعيه إلى خلق نصية شعرية مغايرة في جماليتها، لكن هذا السعي لا يكتمل أمام سعة التجربة المنجزة، وتفتحاتها في الذاكرة المؤسسة، خاصة وأن البنائية الشعرية هنا تقوم على حدود المفهوم الخارج، أكثر من الحالة/ الداخل...
فإذا كانت التسمية "لماذا تركتَ الحصانَ وحيداً" تطرحُ سؤالاً مصيرياً، فإنها في الوقت نفسه تشير إلى تشكيل شعري يلعب الرمز دوراً أساسياً في بنيته، ففي "أرى شبحي قادماً من بعيد" النص الشعري الأول في المجموعة نقرأ: "أطلُّ كشرفة بيت على ما أريدْ
أطلُّ على أصدقائي وهم يحملون من يد المساء: نبيذاً وخبزاً
وبعض الروايات والأسطوانات.."/.
وكما نرى يستغرق الاتكاء على المعطى في التجربة السابقة اجتهاد الشاعر في هذا النص، مما يثير سؤالاً حقيقياً عن علاقة القول الشعري المسبق وذهنية إرساله بالنسيج الداخلي للتشكيل الشعري، إذ يتم البناء الصوري هنا بعين العقل مما يحيلنا إلى فكرة المشاهدة بدلاً من الدلالة، وإلى التبسيط بدلاً من الإيحاء، فتبرز آلية الكتابة بوجهها المسبق على الحالة الشعرية، وتخفت الإضاءات الداخلية للغة، ويتماهى التشكيل الشعري مع لبوساته الخارجية دون أن يتخطى تحديداتها المجردة. وبهذا يضطر الشاعر إلى إعادة لازمة النص الشعري: "أطلُّ على.. " أكثر من عشرين مرة كي يجمع نثارات رؤيته، ويشذّب مباعداتها:
"... أطلُّ كشرفة بيت على ما أريد
أطلُّ على شجر يحرس الليل من نفسهِ
ويحرس نوم الذين يحبونني ميتاً
أطلُّ على الريح تبحث عن وطن الريح في نفسها
اطلُّ على امرأة تتشمس في نفسها..."
والتخيل هنا كما نلاحظ يلامس ولا يمسك بالمتناول أو لنقل لا يتجاوز انكشافه الأولي، لأنَّ التمرس في الكتابة الشعرية لا يعني القدرة الدائمة على موازنة حركة البناء بين الساكن والمتحرك في تركيب النص، فالتشكيل الشعري يبدأ من المتشابه والمعتاد في تجربة الشاعر لا من المبتكر أو الإضافي فالشجر يحرس الليل من نفسه، والريح تبحث عن وطن الريح في نفسها، والمرأة تتشمس في نفسها... وهذه التمثلات التكرارية الأحادية المتطورة تعكس نفسها أيضاً على بناء النص، فإذا كان الشاعر ينجح في تجاوز عتبة الإيقاع الخارجي ـ التفعيلة ـ من خلال الدقة في ضبط الوزن، مستفيداً في ذلك من تجربته الطويلة في حقل الشعر الغنائي، إلا أن مفهوم النجاح هنا يعني التطويع وليس الإفلات من براثن تلك العتبة، ولا نبوح سراً إذا قلنا إن الإيقاع الخارجي يلعب أحياناً دوراً توليدياً في النص الشعري أكثر من المخيلة، خاصة إذا كان البناء الشعري خاضعاً لبلاغة الفكرة المسبقة أكثر من يفاعة الحالة الشعرية، وطفليتها.
فتفعيلة كـ "فعولن" التي اعتمدها الشاعر في هذا النص لم تنجه من شرك التكرار والوقوع في أحبولة القول الثقافي، ومتابعة جرس القافية باحتراس وحذر شديدين:
"/... أطلُّ على رسم أبي الطيب المتنبي
المسافر من طبريا إلى مصر
فوق حصان النشيدْ
أطلُّ على الوردة الفارسية
تصعد فوق سياج الحديدْ
اطلُّ كشرفةِ بيتٍ على ما أريدْ.../".
وهذا البناء كما نلاحظ يثير سؤالاً حقيقياً عن مدى التجديد في تجربة الشاعر. صحيحٌ أنه محكم الصنعة وفق مقاييس النقد "المدرسي السائد" لكنه لا يضيف جديداً إلى ما هو مألوف ومعتادٌ في تجربته، فالشاعر يطل على موجوداتِه من علٍ محملاً إياها نثارات قراءته المسبقة على الحالة الشعرية دونما التفات إلى المساحة الداخلية للتشكيل وتوسعاته الأفقية، وكذلك الأمر في "أيقونات من بلور هذا المكان"، وتحت عنوان "في يدي غيمة" تطالع:
"/... أسرجوا الخيل لا يعرفون لماذا
ولكنهم أسرجوا الخيل في السهل../".
فمن "الأيقونات" تبدأ حركة القص الشعري إذ نجد الخطاب ينطلق من ذروة لحظة خارجية مشبعة بالسرد والوصف والاحتشاد، عبر تفتحات ذاكرة مثقلة بالتفاصيل تسعى إلى استحضار مفرداتها كاشفة مع مشهدية المكان والأسماء، من خلال بنائية تقوم على التفتيت الحسي للمعطيات، وصوغها ضمن تقطيعات زمنية لالتقاط الحالة، وتكثيف امتداداتها، وبعيداً عن الاسقاطات المعرفية للنص وترانا نتوقف عند نمذجة الصور، وتكرارها في تجربة الشاعر "كرائحة الهال والقهوة، والقش، والتبغ والغيمة التي تجرح، والبرتقال، وصرخة البراري و... الخ".
مما يحملنا على الاعتقاد بأن هذه الكتابة ما هي إلا تخطيات شعرية قديمة حاول الشاعر بعثها من جديد.
فالمتابع لشعر "درويش" يلمس هذا التكرار، وإن اختلفت صيغة التوظيف في التشكيل، لكنها لم تضف للنماذج الأولى إضافة حقيقية كما أظن. وينطبق هذا القول على معظم نصوص "الأيقونات" فرغم تعدد مستويات التناول ظلت أسيرة التراتبية في تصعيد الفكرة بشكل عمودي مع التوسعات الخارجية للمعطيات واستخدام بعض تقنيات القص، وكل هذا وذاك ساهم في إرباك العلو الشعري وتشكيله الذي كان يصعد ويهبط وفق مقاربات الشاعر بين المعطى وطريقة معالجته، حتى داخل النص الواحد.
ففي ".. قرويين من غير سوء" ـ على سبيل المثال وليس الحصر ـ يتجلى التجاذب بشكل واضح بين مستويين للغة الشعرية، مستوى خارجي مثقل بالإخبارية والشروحات والتبسيط، ومستوى داخلي ينحو إلى التكثيف والتركيب والإدهاش. ومن المستوى الأول نقتطف: /... لم أكن أعرف عادات أمي ولا أهْلها
عندما جاءت الشاحنات من البحرِ
لكنني أعرف رائحة التبغ
حول عباءة جدي
ورائحة القهوة الأبدية منذ ولدت
كما يُولدُ الحيوان الأليف هنا دفعة
واحدة..:"
ثمًّ نقرأ مستوى آخر داخل النص يتجاوز مشاغلات الحواس الخارجية وتحديداتها المتصورة بل والمنجزة في حوار الذات الشاعرة مع موجوداتها
"/.. نحن أيضاً لتأسرنا
عندما تقع الشمس
عند شجر الحور:
تخطفنا رغبة في البكاء
على أحد مات../".
وهكذا يستمر الصعود والهبوط في التشكيل مع إصرار الشاعر على "ترسيم "أيقونات" بلور مكانه المقترح الذي تطرحه التفاته الذاكرة بمحمولاتها المسبقة على الحالة الشعرية، ولأن هناك رغبة في كتابة "سيرة حياتية" عبر النظر للفعالية الشعرية كحالة مثلى من حالات القبض على التجربة الشاملة كما أسلفنا، فينفتح الباب واسعاً لبروز حركة التفاصيل كوجهٍ للعمل أكثر من كونها خلفية له.. إذ تدفع تلك النظرة بشاعرنا إلى سياقها الخاص الذي يفرض طبيعته ومساره حتى في حركة الأفعال، ومستوياتها الداخلية، فالذاكرة هنا تهيمن على تواتر اللغة وتوثبها، وتحد من مساحة التخييل، وتجبر الشاعر على استخدام جمل مثل "حين وصلنا" و"حين التقينا"، لاستمرار التواصل الداخلي مع الحالة السابقة، وتتبع آثارها في الحالة الجديدة:
"/.. ههنا حاضر لا يلامسه الأمس
"حين وصلنا" إلى آخر الشجرات
انتبهنا إلى أننا لم نعد قادرين على الانتباه
وحين التفتنا، إلى الشاحنات رأينا
الغياب يكدس أشياءه، المنتقاة
وينصب، خيمته الأبدية حولنا.../".
ولا تختلف النصوص اللاحقة في "الأيقونات" عما قبلها حيث يستمر الخط السردي الإخباري بالتصاعد مع خفوت أعلى للتخييل الذي لا تستطيع مهارة الشاعر أن تتجاوز الرموز المقترحة في النص وإسقاطاتها التاريخية:
"/... لماذا تركت الحصان وحيداً؟
لكي يؤنس البيت يا ولدي
فالبيوت تموت إذا غاب سكانها../".
بينما في القسم الثاني من المجموعة يعاود الشاعر الرسم الشفاف للحوار الجمالي مع الذات والعالم، ويبدو كما ألفناه حريصاً على تحريك سياقات لغته وتطعيمها بألق مميز:
"/... حيرة التقليد: هذا الغسق المهرق
يدعوني إلى خفتهِ خلف زجاج الضوء
لم أحلم كثيراً بكِ يا دوريّ
لم يحلم جناح بجناحٍ
وكلانا قلق../".
فكلما اقتربت اللحظة الشعرية من الذات أكثر في شعر محمود علت فضاءات أسئلتها، وأخذت اللغة موقعها الجديدة كأداة كشف وخلق، وغادرت موقعها الوصفي عبر المشاهدة والمفهوم، | |
|